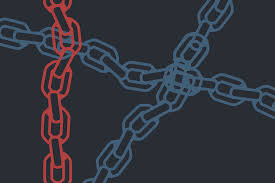هكذا حدث الطرد الهادئ للسوريين من الجولان

(1 من 3)
ترجمة أيمن أبو جبل
التاريخ: يوم أو يومان، بعد انتهاء حرب الأيام الستة، حزيران/ يونيو 1967. امرأة من سكان القرية، ومعها حزمة من الأمتعة، تقف عند مدخل منزلها وتنظر بقلق إلى سيارة (جيب) تابعة للجيش الإسرائيلي. لا يُعرف هل طُلب منها المغادرة أم لا، ربما أدركت أنها لن تكون قادرة على العيش في أمان وحدها في القرية، أو مع عدد قليل من الأشخاص الآخرين الذين لم يفرّوا، وربما لا تزال تتوقع أن الأمور ستنجح، وأنها ستكون في المنزل مرة أخرى. قوات الاحتلال هنا والخوف مفهوم، إنها صورة مؤثرة.
في الصورة: أحد سكان بلدة (فيق) في جنوب هضبة الجولان، يقف عند مدخل منزله المبني من الوحل والطين. جدران البيت من دون جبصين، وبلا نافذة.. البؤس يظهر من كل زاوية. تشابك يديه ببعضهما يعكس حالة الضغط والخوف التي يعيشها، وعيونه قلقة بشأن المصير المجهول القادم. ربما يعُد أيامه الأخيرة، وربما يتساءل: كيف انكسر الجيش الذي كان من المفترض أن يحميه؟ ولماذا اختفى وتركه وبعض جيرانه وحدهم أمام لواء المظلّيين المعادي الذين هبطوا أمامه من عشرات المروحيات؟! يحاول القروي كسب الوقت لكي يستوعب: إلى أين يتجه؟ أين سينام الليلة؟ وماذا يُخبئ له الغد؟ ومن سيعتني بالحيوانات؟ ربما يعتقد أن هذا الكابوس سيزول، بعون الله، وأن هذا الواقع سيعود كما كان!
يظهر السوري من الصورة السابقة في هذه الصورة، وهو الأدنى في مجموعة من أربعة أو خمسة من جيرانه في قرية (فيق) وهم يسيرون وراء جندي إسرائيلي من لواء المظليين، أو ضابط من اللواء 80، يأخذهم إلى نقطة تجمع السجناء المدنيين.. إنها لحظات قلق شديد من القادم.
مجموعة قوامها نحو 25 سوريًا على الطريق، بينهم طفل وامرأة وعجوز، يسيرون على الأقدام، وعلى دراجة، وعلى ظهر حمار. إنهم في طريقهم ليصبحوا لاجئين في بلدهم، وقد أخذوا ما استطاعوا حمله من مقتنياتهم وممتلكاتهم التي تمكنوا من حزمها بسرعة لرحلة ووقت غير معروفين. يشير الطريق الإسفلتي وأعمدة الطاقة إلى طريق رئيسي. من الممكن أن يكون طريق بانياس – مسعدة. نتمنى أن يكون ذلك خيرًا إن شاء الله، وأن تكون طريق العودة إلى المنزل بالحافلة أو السيارة، وأن تعود الحياة كما كانت دائمًا.
مواطنون سوريون في القنيطرة في الأسر، 11 حزيران/ يونيو 1967، بعد يوم من احتلال المدينة ومرتفعات الجولان، وانتهاء حرب الأيام الستة؛ إذ قرر حوالي 500 من سكان القنيطرة، من أصل 35000، التمسك ببيوتهم وعدم الفرار شرقًا، لكن الجيش الإسرائيلي أجبرهم على مغادرتها، وتم تجميعهم في نقاط عدة كمراكز اعتقال، وسجّلت أسماؤهم على عجل، واقتيدوا مباشرة إلى مقر الحاكمية العسكرية الإسرائيلية، وما زالوا مصدومين: كيف سقطت مدينتهم التي طالما افتخروا بها؟ كيف سقطت من دون أن تُطلق رصاصة واحدة، مع أن مدينتهم وكل محيطها كانت محصنة كثكنة عسكرية، ولم يقف الأمر عند سقوط المدينة، بل تحول أهلها فجأة إلى أسرى أذلاء!! جنود الجيش الإسرائيلي يبتسمون ويضحكون ويتصورون لتخليد الذكرى، والسوريون محبطون أذلاء.
فتاة تركب على حمار وهي في طريقها لتصبح لاجئة، يبدو أنها ما زالت لا تعرف ذلك. نظراتها مليئة بالتعب والإذلال، ربما بسبب يدها المكسورة، وفي يدها الأخرى تحمل العلم الأبيض، وهو تأمين مؤقت على حياتها. لا أحد في هذه اللحظة المجنونة من الحياة يعرف ماذا سيحدث، حين يحتل جيش العدو قريتك في ساعتين. بسبب إصابتها لا تحمل معها مقتنياتها من المنزل، حيث تركت كل شيء مع ذكرياتها داخله، من دون أن تعلم أنها لن تعود إليه أبدًا، ستجد نفسها في خيمة في مخيم مهمل للاجئين، ربما يكون بالقرب من دمشق، أو شرق القنيطرة. وستبدأ حياتها من جديد من نقطة الصفر، سيصبح الجولان السوري، بالنسبة إليها، محض تاريخ. وستكون قادرة على رؤيته، من الآن فصاعدًا، في حالة واحدة فحسب: حين تنظر إليه من بعيد.
الطرد الصامت
وضعت حرب حزيران 1967 ما يقارب 100 ألف مواطن سوري أمام مصير مجهول، ففي اليوم الثاني للحرب في السادس من حزيران، حين بدأت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصف المواقع والقواعد العسكرية السورية المنتشرة في كل مكان، ومحيط القرى المأهولة بالسكان التي بلغتها القذائف؛ بدأ السكان الهروب والاختباء حتى تنتهي الغارات الإسرائيلية، ويعودوا إلى ديارهم، لكنهم لم يتخيلوا قطّ أن عودتهم ستكون مستحيلة، مع احتلال الجولان والسيطرة على قراهم، في التاسع من حزيران، مع بدء تحرك القوات الإسرائيلية باتجاه مرتفعات الجولان. في هذ الوقت، لم يهرب من القرى السورية سوى مئات من المدنيين، ومنها القرى الدرزية في شمال الجولان (مجدل شمس وعين قنية ومسعدة وبقعاثا وسحيتا) التي تقع على الخط الحدودي الجديد، حيث تفرق سكانها بعد إخراجهم بوساطات الطائفة الدرزية في إسرائيل، ثمّ تم تدمير تلك القرى، أما قرية (الغجر) العلوية فلم تتضرر، لكونها قرية لبنانية في الأصل، ولم تصل إليها القوات الإسرائيلية.
استغلت إسرائيل حقيقة أن معظم قرى الجولان أصبحت مهجورة، بينما ظهرت مشكلتها الكبيرة في التعامل مع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن هرب المئات من القرويين السوريين إلى هناك، حيث تعرّض الذين اختبؤوا هناك لمعاملة عدائية من قبل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وأصرّ آلاف من السوريين على البقاء في قراهم وبيوتهم، وهم من القنيطرة والمنصورة وصرمان وكفر عقب وعشرات القرى الأخرى.. وقد تُرك أمر التعامل مع أولئك للجيش الإسرائيلي، لكن الشيء المؤكد أن الذين غادروا، إلى الجانب السوري شرقي الحدود الجديدة، لم يُسمح لهم بالعودة، بأي شكل من الأشكال، وقد صرّح القائد العام للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي ديفيد إلعازار، أمام لجنة الخارجية والأمن، في كانون الثاني/ يناير 1968 بالقول: “لا أريد أن يعود أولئك إلى ديارهم، وأحاول منع عودتهم نهائيًا”. وفي اجتماعٍ في مبنى مقر الجبهة السورية في القنيطرة، المقر الجديد لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان، في 11 حزيران/ يونيو 1967 (بعد يوم من انتهاء الحرب) بقيادة وزير الدفاع موشيه ديان ودافيد اليعازر والجنرال إلعاد بيليد؛ أثارت قيادة الجبهة الشمالية قضية مصير مواطني هضبة الجولان الذين بقوا في أراضيهم. ولا يُعرف بالضبط ما حدث في الاجتماع، لكن ما حدث بعده مباشرة يُنبئ به؛ إذ أُلغيت المعاملات النقدية السورية، وحُرم العمال والموظفون بشكل مُهين من أجورهم، وأوقفت المعاشات الحكومية لكبار السن والموظفين المتقاعدين، ورفضت الحاكمية العسكرية فتح المحالّ والمتاجر التي بقيت مغلقة، وجُمّع السكان في أحياء خاصة.
قال أفيشاي كاتز، من سلاح الهندسة 602 في جيش الدفاع الإسرائيلي، في مقابلة مع موقع (نعموش) في 2015: “نعم، تلقّيت أوامر عديدة بعد الحرب، أولًا قبل كل شيء أوامر بتدمير هضبة الجولان فورًا. كانت الفرق التابعة للسلاح تخرج يوميًا لتدمير المنازل وجمع الألغام الأرضية التي تركها السوريون وراءهم، كان هناك عمليات تدمير شامل لقرى كاملة، لم ندع أي منزل، كنا نأتي إلى القرية في الصباح، ونضع 10 كغ من المتفجرات داخل المنزل ونفجّره، كل صباح، كنا نخرج من حورشات التل إلى قرية بانياس والقرى المحيطة، لنفجر المنازل ونعود مساءً”. وأضاف: “في إحدى المرات، قام المهندسون بتفجير منزل على ساكنيه، وقتل جميع السوريين الذين كانوا في المبنى، وبصرف النظر عن نشاط سلاح الهندسة، في تموز/ يوليو 1967، أصبحت القرى السورية مناطق تدريب لوحدات المشاة والمدرعات، في قصرين والقلع وزعورة وجباثا الزيت وغيرها من القرى، واستمر هذا الوضع خمس سنوات تقريبًا، لم يبق أي منزل سوري سليمًا.
على طول الخط الحدودي الجديد، تم وضع حوالي 25 موقعًا لجيش الدفاع الإسرائيلي، وفي سجل يوميات غرفة العمليات التابعة لقيادة الجبهة الشمالية، تفاصيل عن عشرات الاشتباكات مع مواطنين سوريين حاولوا العودة إلى قراهم بعد الحرب، لاستعادة مقتنياتهم وأمتعتهم، وإنقاد ما يمكن إنقاذه من الممتلكات، واستعادة حيواناتهم المصادرة، ومن أجل منع ذلك، نصبت الكمائن مع حلول الظلام، وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على كل شخص شوهد في الظلام، دون إنذار، ودون التحقق من هويته، سواء أكانوا إرهابيين أم مدنيين، وسقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. أما أولئك الذين تمكنوا من التسلل فقد وجدوا أن منزلهم قد اقتُحم ونهب. وتجدر الإشارة إلى حذف عدد غير قليل من الأحداث، من سجل يوميات غرفة العمليات في تلك الأيام. ولنا أن نتساءل اليوم: ما الذي كانوا يريدون إخفاءه.
شكاوى سورية
– في 17 حزيران/ يونيو 1967، أرسلت الأمم المتحدة إلى إسرائيل قائمة بالاتهامات السورية بشأن معاملة السكان المدنيين، ولخّصنا المزاعم السورية وردود إسرائيل وتفسيرها على كل شكوى، حيث اشتكى السوريون من طرد إسرائيل لحوالي 40 ألف مواطن سوري من الأرض المحتلة، وقدمنا تصوراتنا وثلنا إنهم فرّوا مرعوبين وخائفين من الحرب، لكن الجيش الإسرائيلي كان يمنعهم من العودة إلى ديارهم.
– والشكوى الثانية هي استيلاء إسرائيل على قطعان الماشية كلها، وقد نُقل 600 رأس ماشية لاحقًا إلى المستوطنين الإسرائيليين الأوائل الذين قدموا إلى الجولان، ونقل 800 رأس ماشية أخرى إلى المستوطنات والكيبوتسات الشمالية داخل إسرائيل، وبيعت أعداد كبيرة أخرى في الأسواق الإسرائيلية بعد فترة الإغلاق البيطري.
– قدّمت سورية شكوى تتعلق بطرد إسرائيل كل الذكور في منطقة البطيحة، واحتجاز النساء والأطفال، ورفضت إسرائيل هذه الشكوى، وعدّتها باطلة ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.
– قدّمت سورية شكوى إلى الأمم المتحدة، قالت فيها إن إسرائيل تمارس سياسية التجويع ضد السكان المدنيين في الأرض المحتلة، ولا توفر لهم الطعام والغذاء. ورفضت إسرائيل الشكوى جملةً وتفصيلًا.
– شكوى تتعلق باغتصاب سيدة سورية من قبل عدد من الجنود الإسرائيليين، وتوفيت في اليوم التالي، وردّت إسرائيل بأنها لم تسمع بهذه القصة على الإطلاق.
– شكوى تتعلق باعتقال إسرائيل لجميع الذكور والرجال الأصحاء، ونقلهم إلى مكان مجهول. ولم تعترف إسرائيل بذلك.
– شكوى حول إجبار أسرى سوريين على حفر القبور، ثم قتلهم بعد ذلك بيد جنود إسرائيليين. ولم تعترف إسرائيل بالحادثة.
– شكوى حول مقتل سبعة ممرضين، كانوا يعملون في مستشفى القنيطرة. ولم تعترف إسرائيل بالحادثة.
– شكوى حول اعتقال جميع المدنيين الذين خدموا في صفوف الجيش السوري، ونقلهم إلى جهة مجهولة، وتعرضهم مع مدنيين آخرين للتعذيب، بهدف انتزاع معلومات منهم. واعترفت إسرائيل بذلك لكنها لم تعترف باستخدام التعذيب ضدهم.
لم يكن هناك أمر رسمي بترحيل المواطنين السوريين
من يبحث في وثائق جيش الدفاع الإسرائيلي لا يجد أثرًا لطرد وتهجير السوريين من هضبة الجولان. رسميًا، لم يكن هناك أمر من هذا القبيل. علاوة على ذلك، في وثائق جيش الدفاع الإسرائيلي من تلك الفترة، لا يمكن للمرء أن يجد أمرًا صادرًا عن غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة، تحت عنوان تطهير أو تنظيف الأراضي السورية المحتلة، بل إن هناك مستندات تقول إنه لا ينبغي طرد القرويين من الهضبة السورية. ولكن ما حدث على الأرض، عمليًا، كان على العكس تمامًا. السوريون الذين عاشوا في الجولان تُركوا بلا مأوى وبلا ممتلكات. وطُردوا، وانتقلوا إلى مخيمات اللاجئين في منطقة دمشق وشرق القنيطرة. هذه هي نكبة سكان الجولان السوري. النكبة التي لم يذكرها أحد تقريبًا. لقد كانت حرب حزيران على الجبهة السورية، بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، فرصةً للقضاء على القرى أو البلدات السورية وطرد سكانها، وسرعان ما اتضح أن 1967 لا يشبه عام 1948. اليوم هناك رأي عام، هناك سلطات، هناك ضغوط، هناك تهديدات وهناك خوف: ماذا سيقول العالم عن دولة إسرائيل، خاصة في ظل تعاظم الدعاية العربية! ومن الغرابة أن إسرائيل سمحت، في 2 تموز/ يوليو 1967، لجميع سكان الضفة الغربية الذين غادروا إلى الأردن أو الذين تم ترحيلهم، بالعودة إلى ديارهم، لكنها لم تسمح على الإطلاق للسوريين في الجولان، بالعودة إلى بيوتهم.
شددت الرواية الإسرائيلية الرسمية على أن السكان السوريين غادروا طوعًا، لكن هذا ليس صحيحًا، وعندما تذكر العالم مشكلة لاجئي مرتفعات الجولان، في أيلول/ سبتمبر 1967، ردّت إسرائيل بطريقة عنجهية بأن الأمر سيناقش في محادثات مباشرة مع الحكومة السورية. لكن السوريين لم يرغبوا في التفاوض والنقاش والحوار مع إسرائيل، وبكل الأحوال، لم يكن لدى إسرائيل نية لإعادة أي سوري إلى أرضها.
احتلال مرتفعات الجولان و”تطهير” السكان المدنيين السوريين السريع جدًا، كان تتويجًا للعلاقة المشحونة والمتوترة وللعداوة العميقة طوال 19 عامًا من الصراع بين سورية وإسرائيل، وخاصة ما جرى خلال أحداث احتلال منطقة مشمار هيردن في العام 1948 وتدميرها بالكامل (ويعرف السوريون أيضًا كيف يدمرون)، وقصف الكيبوتسات، ومحاولات تحويل مصادر نهر الأردن، وقضية إيلي كوهين. إسرائيل لم تكن بريئة من التهم والشكاوى، ولم تكن بعيدة عن عقلية الانتقام من السوريين، فكانت حرب حزيران فرصة ذهبية لتصفية الحسابات القديمة مع السوريين، حيث احتلت أرضهم وطردت سكانها، ولم تكتف بذلك، فقد ضمتها بالكامل إلى سيادتها لاحقًا. مهجرو الجولان المدنيون وحدهم دفعوا الثمن الأغلى من هذا الصراع، انتقلوا ليصبحوا لاجئين يعيشون اليوم معاناة كبيرة، بسبب فقدان منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وألقي بهم في مخيمات اللاجئين المليئة بالفقر والألم والمعاناة، وعلى الرغم من مرور 53 عامًا على قصتهم، ومن استحالة عودة الجولان في المستقبل المنظور إلى سورية، وعودتهم إلى ديارهم، فإنهم ما زالوا يحلمون بأنهم سيعودون يومًا ما إلى القرية التي وُلدوا ونشؤوا فيها.
طرد السوريين من هضبة الجولان
(2 من 3)
يتناول الفصل الثاني، من بحثنا الخاص بطرد السوريين من هضبة الجولان، الحياةَ في الهضبة السورية قبل حرب الأيام الستة، وشهادات مدنيين سوريين نزحوا من ديارهم وتحولوا إلى لاجئين في بلادهم. * “جاء جندي وطلب منا مغادرة القرية والتوجه نحو القنيطرة، وبدأ بإطلاق النار في الهواء”.
هذا هو المقال الثاني من سلسلة بشأن طرد المواطنين السوريين من هضبة الجولان، ومحو القرى بعد حرب الأيام الستة، حتى عام 1974 في الحقيقة، بعد انسحاب إسرائيل من القنيطرة، لا قبل تدميرها بالكامل. يتناول هذا الفصل الحياة في الجولان السوري قبل حرب الأيام الستة، ويعرض عددًا من شهادات اللاجئين أو النازحين، كما سمّاهم السوريون. ويستند هذا المقال إلى مواد منشورة على موقع “الجولان” ( (jawlan.org وعلى موقع “النكبة” https://nakba-online.tripod.com/ وموقع “ذاكرات“ https://zochrot.org/he/article/54831
تذكرنا قصص النازحين السوريين عام 1967 بقصص اللاجئين الفلسطينيين عام 1948. وروى كثير منهم كيف فروا من قراهم بسبب القصف، وناموا في الحقول وانتقلوا من قرية إلى قرية حتى وصلوا إلى مكان آمن. ازدهرت مرتفعات الجولان وتطورت بعد عام 1948؛ حيث وصل إليها آلاف الفلسطينيين، بعضهم من قرى الجليل الأعلى، بعد أن طردتهم القوات الإسرائيلية. لم تكن الزيادة في عدد السكان بسبب الزيادة الطبيعية، ولكن بسبب الهجرة إلى الجولان من المحافظات السورية، بسبب نموها وتطورها الاقتصادي. وأصبحت مرتفعات الجولان مكانًا مهمًا، من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، لقربها من فلسطين. عشية حرب حزيران/ يونيو 1967، كان حوالى 153 ألف ساكن يعيشون في مرتفعات الجولان، بما فيها تلك المناطق التي لم تحتلها إسرائيل، موزعين في 275 مدينة وقرية ومزرعة. لا يشمل العدد عناصر الجيش السوري الذين خدموا في الجولان وعائلاتهم. كان عدد سكان مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل في حزيران/ يونيو 1967، حوالى 128 ألف نسمة، في مدينة القنيطرة و222 قرية ريفية أخرى. كانت القرى معظمها صغيرة، أقل من 1000 شخص، وكانت عشرات القرى صغيرة جدًا ويسكنها أقل من 100 شخص. تستند هذه البيانات إلى دراسة أجراها الدكتور إيغال كيبنيس، بشأن الحياة السورية في هضبة الجولان عشية حرب الأيام الستة، ونشرت على موقع كاتديرا عام 2003.
بلغ عدد سكان القنيطرة، التي كانت عاصمة المحافظة والمركز الإداري الرئيس في الجولان، ما بين 20 ألفًا إلى 30 ألف نسمة في بلدة فيق، التي كانت عاصمة منطقة فرعية ومركزًا إداريًا في جنوب مرتفعات الجولان، عاش فيها أقل من 3 آلاف نسمة. يعتمد مصدر عيش سكان الجولان أساسًا على الزراعة. حتى في مدن مثل القنيطرة، كانت الزراعة مصدر الرزق الرئيس. ومخصصة للاستهلاك الذاتي للمزارعين، ولم تكن هناك تقريبًا تجارة للمنتجات بين القرى. كانت زراعة الأرض تعتمد على طرق قديمة، وكانت المحاصيل قليلة، مثل القمح والشعير والبقوليات. أما في شمال الجولان فكانت هناك مناطق رعي واسعة، وفي القرى الدرزية على سفح جبل الشيخ انتشرت زراعة الأشجار المثمرة، إضافة الى مصادر الرزق الأخرى كالتجارة والصناعة والبناء والخدمات والنقل، كما عمل القرويون في وظائف متاحة لمصلحة الجيش السوري. كانت بيوت الفلاحين التقليدية في جنوب الجولان مبنية في الغالب من الطين، وكان يخلط في بعض الأحيان مع أحجار البازلت. تكونت المنازل من غرفتين؛ وكان أفراد الأسرة ينامون على فرش وبطانيات منتشرة على طول الجدران في غرفة المعيشة،و في تجاويف الجدران، تخزّن الأدوات المنزلية، معظمها مقتنيات نسائية مثل أدوات المكياج والخياطة والحياكة، وكذلك المجوهرات والحلي والألعاب. وكانت الغرفة الثانية مخصصة بصفتها مخزنًا للمواد الغذائية وأدوات العمل، أما زيت الزيتون كان يوضع في إناء فخاري كبير.
خارج المنزل كان هناك فناء محاط بجدار حجري وبمحاذاته زاوية مخصصة للطبخ والخبز وزاوية خاصة للماء حيث يُخزّنُ في إبريق ضخم. كان هناك جهاز خاص لصنع الزبدة. أما السماد المجفف فقد استخدم مادة للتدفئة. وفي داخل الفناء كانت تعيش المواشي والأغنام والأبقار أيضًا، والدجاجات التي تجول في الفناء. طورت الحكومة السورية الجولان أساسًا لأغراض عسكرية، فشقت الطرقات المعبدة، وأنشأت خطوط الكهرباء والهاتف وشبكة المياه المنظمة. وتمتع السكان المدنيون بهذا التطور بشكل غير مباشر، وبخاصة أولئك الذين يسكنون في القرى على الطرق الرئيسة. واستفادت من هذا التطور أكثر من 50 قرية وبلدة، أما القرى الأخرى فقد استخدمت مياه الينابيع ومياه الجداول ومياه الأمطار. كان هناك أكثر من 100 مدرسة ابتدائية في أنحاء الجولان جميعها، وحوالى 10 إلى 15 مدرسة ثانوية فقط مبنية من الباطون. في المدارس الابتدائية، كان عدد الطلاب الذكور ضعف عدد الطالبات، وكانت معدلات التسرب عالية في طبقات الصف الأول؛ حيث كانت نسبة الذكور الذين تسربوا أعلى من نسبة الإناث في طبقات الصف السادس. بالنسبة إلى المدارس الثانوية، كانت نسبة الذكور أعلى بكثير من نسبة الإناث. وكانت الخدمات الصحية في الجولان محدودة للغاية؛ حيث وجدت العيادات الطبية في القنيطرة وفيق فحسب، وربما في مجدل شمس أيضًا. أما بالنسبة إلى خدمات المستشفيات المدنية فلم تكن متوفرة على الإطلاق.
الطرد والتهجير من الجولان في عيون الإسرائيليين
يتجاهل التأريخ الصهيوني تمامًا طرد سكان الجولان عام 1967 وتدمير قراهم. ويقول التفسير الإسرائيلي الرسمي، الذي دعمه وأيده المؤرخون الصهاينة، إن سكان الجولان هربوا عام 1967 كما هرب الفلسطينيون عام 1948. على سبيل المثال، يقول معجم “كل مكان وموقع” الذي نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية عن مرتفعات الجولان: “في خلال حرب الأيام الستة، احتل جيش الدفاع الإسرائيلي مرتفعات الجولان وفر سكانها معظمهم”. فيما تضمن معجم آخر شبه عسكري بعنوان “قاموس لأمن إسرائيل”، لمؤلفيه إيتان هابر وزئيف شيف، معلومات عن سكان الجولان جاء فيه: “معظمهم هربوا وتركوا بيوتهم”، من دون أن يذكر أو يشير إلى أنهم مع نهاية الحرب حاولوا العودة الى قراهم لكنّ الجيش منعهم من ذلك بعدها دمر بيوتهم. وقد ذهب المؤرخ الإسرائيلي ناتان شور إلى أبعد من ذلك حين ادعى أن قيادات الجيش السوري أمرت سكان الجولان المدنيين بالتخلي عن منازلهم وممتلكاتهم ومغادرة قراهم على الفور، والتوجه إلى الداخل السوري، ولم يبق من القرى السورية سوى البلدات الدرزية التي لم يستمع سكانها إلى هذه القرارات، وسُوّيَتْ القرى بقيتها بالأرض ودمرت بالكامل، فيما كتب مؤرخ وكاتب إسرائيلي آخر يدعى ميخال أورين في كتابه “ستة أيام من الحرب” عن الإحراج الذ ي سببه رحيل 95 ألف مواطن سوري من مرتفعات الجولان في 10 حزيران/ يونيو، وضرب أمثلة على الأشخاص الذين فروا. وبحسب قوله، فإن “الدروز والشركس” وحدهم بقوا في أماكنهم “للترحيب بالمحتلين”.
ظهرت أدلة على قضية الترحيل بين الحين والآخر في المقالات والكتب الإسرائيلية، وبخاصة في الدعاوى السياسية. كان من أوائل الذين تناولوا هذا الأمر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد رحبعام زئيفي، الذي ادعى في جدال مع عضو حركة البلماح المتطرفة في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن رجل البلماح ديفيد إلعازار (دادو) طرد سكان القرى السورية جميعهم من مرتفعات الجولان بعد حرب الأيام الستة، بموافقة “رئيس الأركان إسحق رابين، ووزير الدفاع موشيه ديان، ورئيس الوزراء إشكول. وأشار إسرائيلي آخر إلى قضية المهجرين السورين من الجولان، وهو الجغرافي البروفيسور أرنون صوفر، الذي قال أمام الكاتب ديفيد غروسمان: “لقد طردنا في مرتفعات الجولان 70 ألف سوري في يومين”. أما المؤرخ بيني موريس، فقد كتب في كتابه “الضحايا” أن ما بين 80 و90 ألف مواطن هربوا أو طردوا من مرتفعات الجولان. وبحسبه، فقد سعى قادة الجيش الإسرائيلي ” إلى إخلاء السكان المدنيين من مرتفعات الجولان، وقد فروا فرارًا كليًا تقريبًا في أثناء عمليات والقصف التي نفذها الجيش الإسرائيلي في أنحاء المنطقة جميعها يومي 5 و 8 يونيو / حزيران، وفي أثناء الهجوم البري على الأرض في 9-10 يونيو / حزيران”. أما الصحفي البريطاني باتريك سيل فقد كتب أن “إسرائيل نهبت القنيطرة وأخلت القرى المحيطة بها، وفي الأشهر الستة التي تلت الحرب، رحّلت “90 ألف شخص” بالقوة والعنف “إلى سورية، وانضم هؤلاء إلى 30 ألفًا آخرين فروا في أثناء القتال. وأكدت المؤرخة تابيثا باتران أنه “في الأشهر الستة التي أعقبت الحرب، طردت إسرائيل 95 ألف شخص آخرين عن طريق تدمير القرى، وقطع إمدادات المياه والغذاء عنهم، وترافق ذلك مع التهديد بالتعذيب والإعدام لمن يرفض المغادرة. وأجبر السكان على ترك ممتلكاتهم وراءهم، من محال تجارية مليئة بأطيب الأصناف والمواد، وقطعان الماشية والماعز، والملابس والأدوات المنزلية والأراضي والمنازل وكروم العنب وبساتين التفاح. إن طرد السكان المدنيين من الجولان السوري ومحو وجودهم من على وجه الأرض قصة تكاد تكون غير معروفة في الخطاب الإسرائيلي. إنها عملية فريدة من نوعها بسبب ارتفاع معدل الترحيل خلال فترة قصيرة: وصلت نسبة سكان الجولان الذين جرى محوهم وطردهم إلى 96%، ولم يبق إلا حوالى 7000 شخص في القرى الموجودة في شمال الجولان.
منع العودة
لمنع اللاجئين السوريين الذين فروا إلى سورية من العودة إلى قراهم في الجولان، هددت إسرائيل بإطلاق النار على أي شخص يدخل إلى الأراضي المحتلة. وأعلنت الحكومة العسكرية الإسرائيلية القرى المهجورة “مناطق عسكرية مغلقة”، وفي الوقت نفسه بدأ الصهاينة في تدميرها، وكان يُمنع أو يُغرّم كل من يُقبض عليه وهو يتسلل إلى قريته. تدريجيًا، بدأت المستوطنات اليهودية في الظهور في الجولان بدلًا من القرى العربية السورية. في 1969، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة مدتها عشرة سنوات، تضمنت ضم مرتفعات الجولان إلى الدولة اليهودية، واستيطان 50 ألف مستوطن إسرائيلي، وإنشاء مدينة يسكنها 30 ألف نسمة. وبمرور الوقت أُنشئت 33 مستوطنة في الجولان المحتل، (34 مستوطنة-المترجم) ينتشر بعضها على الأرض والقرى السورية بقيتها، ويعيش فيها حاليًا أكثر من 30 ألف مستوطن يهودي (23 ألف مستوطن-المترجم). يستخدم المستوطنون حوالى 5% من الأراضي الزراعية في الجولان؛ 11% منها مساحات مفتوحة و17% محميات طبيعية، إضافة إلى مساحة جبل حرمون معظمها. وتستخدم الأراضي بقيتها للرعي أو بوصفها معسكرات ومناطق عسكرية مغلقة لأغراض التدريب، بالإضافة إلى حقول ألغام. يوجد في الجولان حوالى 60 معسكرًا للجيش الإسرائيلي و67 حقل ألغام، (2000 حقل ألغام- المترجم) يقع بعضها في داخل القرى العربية المأهولة أو بالقرب من نفوذها. ويستخدم السكان الدروز الذين بقوا في الجولان 75 كيلومترًا مربعًا من الأرض فقط، ومن أصل 31 مليون متر مكعب من المياه تُضخ سنويًا، هناك 28 مليونًا مخصصة للمستوطنين، وأربعة ملايين للسكان الدروز. يدفع الدروز ثمن المياه لشركة مكوروت، رغم أن المياه معظمها تُسحب من الآبار الموجودة في أراضيهم التي حفرتها إسرائيل وأعدتها. ومنذ عام 1967، استشهد 21 شخصًا وأصيب 31 آخرون برصاص قوات الاحتلال، وحُكم على نحو 700 شخص بالسجن بسبب نشاطاتهم السياسية.
فيما يلي بعض الشهادات من سكان الجولان السوري
فداء الصالح: أعيش الترحيل الثاني من جانب الأسد
“عاش والدي عقودًا على أمل العودة إلى مسقط رأسه في الجولان، والآن أعيش مأساته نفسها مرتين؛ مرة عندما مُنحت صفة “نازح”، نازح منذ ولادتي، والأخرى بعد حملة التهجير القسري إلى شمال سورية بعد حرب الأسد ضد الشعب السوري. في أيار/ مايو 2018. مع انطلاق الحافلات باتجاه الحاجز الروسي في سورية راودتني الفكرة: ما الفرق بين تاريخ 5. 5. 2018 و تاريخ 10. 6. 1967؟ شعرت أن وجوه المحتلين هي نفسها ما دامت النتائج متشابهة. لقد سخرت من صفة النازح الملتصقة بي. ماذا سيتغير بعد ذلك؟ قلت لنفسي، محاولًا البحث عن سيناريوهات جديدة محتملة عن الحياة التي تنتظرني في شمال سورية،
المكان الذي يسمح لي بالهروب من الموت والخراب والقتل الذي يقوم به الأسد والروس والإيرانيون في أنحاء سورية جميعها في سبيل الحرية وإنهاء حكم البعث.
في الحافلة الى الشمال السوري، لم يتمالك الحاج محمد نفسه عند وصولنا إلى عدرا العمالية، كانت عيناه تذرفان بسخاء وصمت أيضًا، جميعنا كنا ننتظر الوقت المناسب للتخلي عن كبريائه. حاولتُ مواساته، اقتربتُ منه، سألتُهُ مازحًا: «أي لما طلعتو من الجولان بالـ 67 طلعتو مشي على رجليكم، والزنكيل فيكم طلع على ظهر حمار، وهلأ طالع بباص ومو عاجبك». أفرجَ عن ابتسامة شاحبة، عدّلَ من جلسته، وكأنه أراد أن يزيل همًّا يحمله كجبل منذ سنوات، ذلك الهم الذي يتكرر أمامه اليوم، وقال: اليوم أنا اعرف إلى أين سنصل هناك خيمة تنتظرني. وأضاف: “عندما رُحّلْنا من الجولان كان عمري 17 عامًا، كنت طالبًا في المدرسة الثانوية. في صباح 10 حزيران / يونيو 1967 سمعنا من إذاعة دمشق بيان سقوط القنيطرة، وبدأت الوحدات العسكرية في التراجع وترك معظمهم أسلحتهم وفروا. كانت الطائرات هي الشيء الوحيد الذي رأيناه. بدأ الناس بمغادرة الأماكن وأُفرغت القرى والمزارع من سكانها. ذهبوا جميعًا إلى مناطق في القنيطرة ثم تفرقوا في أنحاء سورية. جاء بعضهم إلى درعا وآخرون إلى دمشق وحمص. في 1967 عاش الناس بهدوء حتى طردوا. عندما دخل اليهود كنا خارجها بالقرب من البستان، تحت ظلال الأشجار. عندما عدنا إلى القرية كان هناك عدد من جنود ودبابات اليهود. كنا خائفين جدًا. جاء جندي وطلب منا المغادرة والسير باتجاه القنيطرة. بدأ أصدقاؤه إطلاق النار في الهواء. طلبنا منهم بالإشارة العودة إلى المنزل وأخذ بعض مقتنياتنا. لم يوافقوا. كان أحدهم رجلًا نبيلًا، اقترب منا وقال بلغة مشابهة للعربية: “ابتعد بسرعة، وإلا سنطلق عليك النار. التفتَ إليَّ وهو يقول: «الآن أنت تعرف إلى أين ستتجه، وأن خيمة في مكان ما بانتظارك، أما وقتها، فقد افترش الأهالي التراب وملؤوا البساتين. خفّفَ الصيف من معاناة الأهالي الذين تفيؤوا في ظلال الأشجار، وبين حين وآخر كان هناك من يأتينا ببعض الطعام إغاثة، ولكن المصيبة الأكبر كانت مع دخول الشتاء، إذ سكن الناس حظائر الأغنام، وبعضهم بنى بيوتًا من طين. باع كثيرون مواشيهم لتأمين الغذاء الكافي، أما المدارس فباتت حلمًا بعيدًا، وإن وُجدت فلم يكن الأهالي يملكون ثمن قلم أو دفتر، وبات البحث عن عمل لتأمين لقمة العيش الشغل الشاغل للصغير والكبير»
خسر السوريون الحرب. لقد أصبح اليهود سادة هذه الأرض
كانت عائلتي من سكان القنيطرة منذ عام 1952. حين اندلعت الحرب كان عمري 19 عامًا، وكنت أعمل في الخياطة. لوحظت قبل الحرب حالة استنفار وتجهيزات عسكرية؛ حُفرت الخنادق خصوصًا في المراكز الحسّاسة مثل ساحة العقيد قرب ساحة الضباط، واهتم الناس بجمع المؤن. في الصباح سمعت أن الحرب بدأت. تجمهر الناس وطافوا في الشوارع هاتفين: “بدنا نحارب.. بدنا نحارب”. وجّهَت أول ضربات العدو نحو مبنى الأركان. توجّهنا إلى أحد مراكز الجيش كي نحصل على السلاح، وبينما نحن متجمهرون هناك تعرض المركز لقصف طائرة إسرائيلية، وما زلت أذكر كيف غطّانا الغبار والتراب. بعدها قضينا أيامًا ثلاثة في البيوت أو في الملاجئ. بعد ثلاثة أيام قرّر والدي أن ننتقل إلى مجدل شمس، أعطاني يومها 500 ليرة، واستأجر لنا سيارة (لرجل من بانياس- سيارة لاند روفر). في الطريق كنّا نوقف السيارة وننبطح أرضًا كلما رأينا طائرة إسرائيلية محلقة ، إلى أن وصلنا إلى مجدل شمس. عرفنا أن اليهود وصلوا إلى مشارف مجدل شمس فذهبت برفقة بعض الأصدقاء إلى بركة رام كي نتفرّج عليهم، خصوصًا أن إشاعات كثيرة كانت تُحكى عنهم وعن أشكالهم. عندما لمحونا هناك هجم علينا بعض الجنود وصوّبوا أسلحتهم نحونا، ثمّ أمرونا بالركوع. ظننا أنهم سيطلقون النار. اقتربوا منا وفتّشونا، ثمّ سلبوا منّا ما في جيوبنا كله، حتى ساعاتنا وسلاسلنا، (سلبوا مني الخمسمائة ليرة التي أعطاني إياها والدي)، وأمرونا أن نغادر راكضين. وصلنا مزارابا ذر الغفاري وكلّنا أسف على ما خسرناه، فأنا مثلًا خسرت (خمسمائة ليرة سورية) وكانت في ذلك الوقت مبلغًا كبيرًا، طبعًا هذا بالإضافة إلى خسارتنا الكبيرة في الحرب. فكر أحد الأصدقاء في أن نرشوهم بالكرز كي يعيدوا لنا أشياءنا. فعلًا، توجّهنا إلى إحدى الأراضي وقطفنا كمّية من الكرز ثم عدنا إلى الجنود. صوّبوا أسلحتهم علينا مرّة أخرى، أما نحن فصوّبنا نحوهم الكرز. استهجنوا هذه الفاكهة الغريبة، ولكي نبعد عنهم الشكّ أكلنا بعض الحبّات، ثمّ في غضون دقائق لم يكن هناك كرز؛ أكلوه كالمجانين. في النهاية نجحت خطّة الكرز وأعادوا إلينا أغراضنا. بعد أن دخل الجيش إلى مجدل شمس، قرر البعض الرحيل عن القرية، لكنّ مجموعة من مشايخ القرية، على رأسهم الشيخ المرحوم أحمد طاهر أبو صالح، وقفوا في طريقهم واعظين إياهم بعدم ترك القرية مهما حصل.
قبل الحرب بسنة انتقلنا للعيش في القنيطرة. كان أبو غسان يعمل في كي الملابس. وقبل الحرب بقليل عُدنا إلى مجدل شمس. في الصباح سمعنا صوت الحرب، نهض الناس مذعورين، خصوصًا بعد أن سمعنا أن اليهود احتلّوا القنيطرة. كانت الحرب مفاجئة للجميع، وكانت سريعة بحيث لم ندرِ كيف وصل اليهود إلى كلّ مكان، حتى أننا لم نشعر بالحرب أصلًا، وكانت وقافلة الراحلين من قرى الجولان كبيرة. مرّ البعض من مجدل شمس (من قرية جباثا الزيت، زعورة، عنفيت) واستضافهم أهل القرية، (قسم كبير تجمع في مدرسة الساحة)، ثم قُدّمت لهم المساعدة في العبور باتجاه دمشق. في ذلك الوقت كانت ابنتي فريال طفلة صغيرة، اقترب منها أحد الجنود اليهود ليعطيها الحلوى فرفضت وصاحت به: “أنتم شياطين”، فدهش وراح يضحك هو ورفاقه.اعتقدنا أن المسألة لن تستمر سوى أيام ويرحل اليهود قريبًا عن الجولان. لكن ذلك لم يمنع البعض من التفكير في الرحيل عن القرية، ولولا بعض المشايخ الذين أوقفوهم لكانوا رحلوا. بعدما هدأت الأوضاع كان أصحاب البيوت في القنيطرة يطلبون التصاريح من الحاكم العسكري لزيارة بيوتهم، وعندما طلب زوجي تصريحًا أُلقيت عليه عقوبة الإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر؛ وهكذا كُتب علينا أن نعيش تحت الاحتلال، بعد حرب بدأت وانتهت برمشة عين. اعتقلت السلطات الإسرائيلية زوجي (أبو غسان) في شباط/ فبراير عام 1973، وكان وقتها يعمل في إيلات مع مجموعة من أصدقائه الذين اعتُقلوا معه. وقتها كان لنا خمسة أبناء أكبرهم عمره عشر سنوات. شعرت أنه سيُسجن مدّة طويلة. في البداية منعونا من زيارته، وكان قد تعرّض للتعذيب القاسي، لكنه على الرغم من ذلك لم يعترف بالتهم المنسوبة إليه. في إحدى جلسات المحكمة احتجزوني، وأدخلتني امرأة إلى غرفة التحقيق وحاولت تفتيشي بصورة مهينة، فدفعتها عني وصرخت بها. سمعني ضابط في الخارج وقال لي بعدما خرجت من الغرفة: “نهاد، لماذا نسمع صياحك دائمًا؟” فقلت له: “أنتم من يجبرني على ذلك”، فقال لي: “نهاد، أنت تشكّلين خطرًا!” من المشاهد التي ما زلت أذكرها كل يوم، أنه في إحدى جلسات المحكمة قلت لابني الصغير آنذاك (جميل) أن يحبو من تحت المقاعد نحو أبيه خلف القضبان. فعلًا، استطاع أن يصل إليه من دون أن يلحظه أحد، قال له: “بيي أني جميل”. كان مشهدًا مؤثّرًا، حاول الحراس أن يبعدوه، لكن الحاكم أمرهم بتركه، ومن يومها سُمح لأبناء المعتقلين بالاقتراب من آبائهم. أمضى أبو غسان 12 عامًا في السجن من أصل 13 عامًا، وطيلة تلك الفترة كنت أمًا وأبًا لأطفالي، أعمل كي أوفّر لهم احتياجاتهم كلها، وعلّمتهم أن حب الوطن أسمى شيء في الدنيا.
شهادة الأب جورج من داخل سورية: دخلت الكنيسة التي بنيتها بيدي، يا له من مشهد مروع
كان عام 1976 مأساة للأمة العربية ومحرقة للرعاة وكنائس القنيطرة التي انتهينا من بنائها وكنا فخورين بها. تبرعت كنائس أخرى ومؤمنون آخرون بأيقونات ثمينة للكنيسة، وجلبنا حجارة رخامية من إيطاليا لأسوار الكنيسة، وأحضرنا المصابيح من بلد آخر، وكانت الكنيسة جميلة. دخل الإسرائيليون إلى مدينتي القنيطرة التي كانت تعرف بزهرة الجولان.
أدى احتلال عام 1967 إلى تهجير أهالي القنيطرة. لقد أجبروا على مغادرة منازلهم. حتى بعد سبع سنوات أخرى كنا نظن أننا سنعود. بعد أشهر قليلة من حرب أكتوبر 1973 غادر الجيش الإسرائيلي القنيطرة. كنت من أوائل الذين دخلوا إلى المدينة، على وجه الدقة ما تبقى منها. دخلت إلى الكنيسة التي بنيتها بيدي. يا له من مشهد مروع! دُمّرَتْ أجزاء كثيرة منها، كانت عارية؛ الها. الصليب، الأجراس، المصباح، الصور الثمينة وحتى النوافذ المزخرفة، سُرقت أو تحطمت. كانت الأسوار من دون حجارة الرخام الكريمة. لم أجد بيتي بين أنقاض الكنيسة. حتى المقبرة دُنّسَت. وكسرت شواهد القبور والقبور بالبنادق والقنابل اليدوية. لقد سألت نفسي مرارًا وتكرارًا: كيف يمكن لشخص أن يقوم بعمل فظيع كهذا؟”.
طرد السوريين من الجولان
(3 من 3):
“قصة الدروز” من وجهة النظر الإسرائيلية
الأحد 11 حزيران/ يونيو 1967، أصبحت الهضبة السورية مجروحة ومذهولة، بعدما أنهت كتائب الجيش الإسرائيلي احتلالها في الليلة السابقة، وبذلك انتهت حرب الأيام الستة، ومن بين حوالي 130 ألف مواطن في الهضبة، لم يبق سوى عدد قليل من المدنيين، في مدينة القنيطرة وفي القرى المحيطة بها.
وفي مقابلة مع مانو شاكيد (قائد الفوج الثالث مشاة في الجيش الإسرائيلي، إبّان حرب الأيام الستة)، اعترف بوجود أمرٍ غير مكتوب: “التحقق من عبور المواطنين السوريين في الهضبة السورية الحدود ومن المغادرة وعدم العودة”. وعندما سُئل كيف حدث ذلك؟ أجاب: “أتيناهم وقلنا لهم يجب أن ترحلوا، وكان هناك شركس ودروز ومسلمون. كان الشركس في الواقع لطفاء، لكننا لم نطرد الدروز. أتيت إلى قراهم للقائهم، حاملًا معي سلاحي بمرافقة بعض الجنود، واجتمع أمامي رؤساء القرية وتحدثت إليهم قليلًا بالعبرية، وبقليل من الإنجليزية، ثم قال لي أحدهم: (اسمع، أنا درزي، وهذا بيتي، وهذه قريتي، إسرائيل ليست دولتي. إن كنتم جيّدين معنا، فسنكون أصدقاء، وإن قررتم طردنا من أرضنا فسوف نقاتلكم، وإننا نعرف كيف نقاتل. قد تفوز أنت في القتال، لكن عليك إعادة التفكير في كل خياراتك). قلت لهم إنني لن أفعل أي شيء ضدكم. “
هذا المقال هو سلسلة من قصة تهجير مواطني الجولان السوري بعد حرب الأيام الستة. وهذه المرة نتناول قصة الدروز الذين لم يُطردوا.
من حسن حظ السكان الدروز في هضبة الجولان في حزيران/ يونيو 1967، أنهم لم يفقدوا منازلهم وأراضيهم وقراهم، مثل باقي سكان الجولان السوري. وبحسب إحصاء السكان في آب/ أغسطس 1967 الذي أجرته الإدارة العسكرية في هضبة الجولان، بلغ عدد سكان قرية مجدل شمس 2918 نسمة، و 1425 في بقعاتا، و 705 في مسعدة، و 578 في عين قينية، و 173 في سحيتا. وتكشف هذه المعطيات أن قرية (مجدل شمس) لم تكن مهجورة قط، وأن قريتا (مسعدة وسحيتا) كانتا مهجورتين جزئيًا. سُمح لسكان هذه القرى بالبقاء، كجزء من سياسة إسرائيل المتعاطفة مع الدروز، تمامًا كما حدث في عام 1948، ولم تطردهم إسرائيل. لم يُجبر سوى سكان قرية (سحيتا) على ترك قريتهم في عام 1970، حيث كانت قريبة جدًا من الحدود، ثم دمّرت لاحقًا، وانتقل معظم سكانها إلى قرية (مسعدة). ويقدّر عدد السكان الدروز في مرتفعات الجولان اليوم بنحو 26 ألف نسمة.
مع نهاية حرب الأيام الستة، توجّه قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل، إلى رئيس الوزراء ليفي أشكول، ووزير الدفاع موشيه ديان، ووزراء وشخصيات أخرى، وناشدوهم معاملة أبناء الطائفة في الجولان بطريقة حسنة. وفي رسالةٍ أرسلها المعلمون في قرية (دالية الكرمل) في 22 حزيران/ يونيو 1967 إلى رئيس الوزراء ليفي أشكول، ورد قولهم: “نحن، المعلمين الدروز في دالية الكرمل، نفتخر بكوننا مواطنين في هذا البلد، ونثمن الانتصارات الرائعة للجيش الإسرائيلي، التي احتل خلالها الهضبة السورية، حيث يعيش حوالي 8000 درزي، وكوننا مواطنين يخدم أبناؤنا في جيش الدفاع الإسرائيلي، ولكون السكان السوريين قد تعرّضوا للاضطهاد الشديد خلال فترة النظام السوري؛ نطالبكم بالاهتمام بمصير الدروز المذكورين، وتزويدهم بالمواد الغذائية والإمدادات اللازمة، والتفكير بمصيرهم خلال أي مفاوضات مع سورية، خشية الانتقام منهم، كما فعلوا بهم في فترات سابقة”.
لكن إسرائيل، على الرغم من طردها سكان القرى السورية الأخرى، لم تفعل، ولم تكن لديها النية بإلحاق الأذى بالدروز من هضبة الجولان، أو إزالة قراهم؛ إذ كان في خلفية القرار الإسرائيلي (الإبقاء على الدروز في الجولان)، إمكانية لإقامة دولة درزية تشكل منطقة عازلة بين إسرائيل والأردن وسورية. وقد شهد التاريخ سابقًا مثل هذه الدولة في العام 1921، في أثناء الحكم الفرنسي لسورية، واستمرت مدة 15 عامًا تقريبًا. وكان صاحب الفكرة في تجديد فكرة إقامة هذه الدول الوزير إيغال ألون الذي أثار الموضوع مع رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون منذ عام 1946، وكررها عند انتهاء حرب الأيام الستة. في محادثات مع رئيس الوزراء أشكول وموشي ديان وإسحاق رابين، وكبار مسؤولي الموساد وقادة المجتمع والدولة في إسرائيل، حيث حاول ألون تحقيق رؤيته لتأسيس جمهورية درزية، تمتد عبر جنوب سورية، وتكون حليفًا لإسرائيل. ومن المفترض، وفق الفكرة، أن تكون القرى الدرزية في شمال الجولان جزءًا من دولة جبل الدروز، إلا أن الفكرة لم تنضج في الواقع. اعتقد المسؤولون في إسرائيل أن السكان الدروز سيكونون ممتنين جدًا لإسرائيل، بسبب حرصها على سلامتهم وإبقائهم في أراضيهم وقراهم، لكن لم يكن هذا هو الحال معهم. فقد أعلن السكان الدروز رفضهم السلطة الإسرائيلية، وعاملوا الحكومة الجديدة بعدائية شديدة، وأعلنوا استمرار ولائهم لسورية. في بداية تلك الفترة، فُرض حظر تجول ليلي على القرى الدرزية، من الخامسة مساءً حتى الفجر، ومُنعوا من مغادرة القرى نهارًا.
في الأيام الأولى بعد احتلال مرتفعات الجولان، بدأ الدروز التنظيم بالفعل، للحفاظ على هويتهم وأراضيهم وكرامتهم الوطنية، وطوّروا مؤسسات مستقلة، وعززوا التضامن المجتمعي في صفوفهم، والتزموا بالرموز الوطنية السورية، وظلوا على اتصال بوطنهم، ورفضوا قبول بطاقات الهوية الإسرائيلية، بالرغم من موافقة عدد قليل منهم فقط على التعاون مع الحكومة العسكرية الإسرائيلية. بمعنى ما، وجد الدروز أنفسهم بين المطرقة والسندان، وقالوا للحكومة الإسرائيلية وللمسؤولين العسكريين أشياء جميلة ومريحة، وذلك بحسب ما جاء في وصف قائد المنطقة الشمالية آنذاك دافيد ألعازر، في تقريره أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنسيت الإسرائيلي في كانون الثاني/ يناير 1968، حيث قال: “أنا زائر وضيف منتظم ودائم، في بيوت الدروز في مجدل شمس، والدروز سعداء بالحكومة الإسرائيلية، وبما تقدمه لهم من خدمات مثل مكاتب البريد والعيادة الطبية ومراكز الهاتف، وشق الطرق إلى دور العبادة والأماكن المقدسة، والخدمات الاجتماعية، تلك الأمور لم يتلقوها منذ عشرين عامًا في أثناء الحكم السوري، صحيح أن هناك عائلات درزية لديها أبناء يخدمون في الجيش السوري. لكنني قدّمت لهم وعدًا: (كل عسكري أو ضابط يهرب من الجيش السوري أو يرغب في العودة إلى الجولان، سنستقبله بترحاب بعد خضوعه لاستجوابات بسيطة، ويعود إلى بيته في الهضبة السورية)، وبالفعل عاد عشرات منهم خلال تلك الفترة”.
وعلى الرغم من ذلك، لم يكن كلّ الدروز في الجولان سعداء بالحكومة الإسرائيلية على أرض الواقع، معظمهم بدأ نشاطهم العدائي ضد إسرائيل بعد احتلال الهضبة مباشرة، وانخرط العديد منهم في خلايا سريّة، لجمع معلومات عسكرية ومدنيّة عن إسرائيل، ونقلها إلى المخابرات السورية، كانت عمليات التسلل عبر الحدود كثيرة جدًا، إذ كانت الحدود في تلك الأيام مخترقة، وكان الدروز يعبرونها من دون مشكلات، لنقل المعلومات وتلقى توجيهات وتعليمات. وفي وقت مبكر من شهر أيلول/ سبتمبر عام 1967، تم اعتقال أول درزي من الجولان، بتهمة التجسس لصالح سورية. وفي عام 1973 تمّ الكشف عن أكبر شبكة تجسس سورية عملت في صفوف السكان الدروز في الجولان تعمل لصالح سورية، تزعمها “شكيب أبو جبل”، من سكان مجدل شمس، وكان ضابط مخابرات سوري قبل حرب الأيام الستة، لم يعد إلى قريته، إلا في عام 1969، كجزء من عملية جمع الشمل بين العائلات الدرزية، حيث سمح له بالعودة، بعد أن تعهّد بأنه لن يعمل ضد أمن إسرائيل.
القبض على شبكة تجسس
استطاع شكيب أبو جبل، بناء علاقات قوية مع رجالات الحاكمية العسكرية في الجولان، ولم يف بوعده الذي قطعه على نفسه، بعدم المسّ بأمن دولة إسرائيل، حيث أنشأ شبكة تجسس سرية ضمّت حوالي 60 شخصًا، عملوا في أماكن مختلفة في شمال البلاد، وجمعوا كل المواد الممكنة، ومن ضمن ذلك المعلومات المرئية مثل الصحف، ونقلوها إلى السوريين. واكتُشف أمر الشبكة في كانون الثاني/ يناير 1973، بعد أن انطلق نجل شكيب أبو جبل (عزّت) البالغ من العمر 21 عامًا في ليلة ثلجية إلى الحدود، لتوصيل المواد إلى المشغلين السوريين. وسقط في كمين لحرس الحدود الإسرائيلي، وقُتل هناك وكان بحوزته مواد تشمل أسماء ناشطين من القرى الدرزية، خمسة منهم اعتقلوا في مدينة إيلات جنوب إسرائيل. وقد حوكموا، وصدرت عليهم أحكام بالسجن، بحسب شدة الجرائم التي ارتكبوها.
حُكم على شكيب أبو جبل بالسجن مدة 315 عامًا، 30 عامًا عن كل تهمة من التهم العشرة المنسوبة إليه التي أدين بها، لكن أُطلق سراحه بعد 11 عامًا، في عملية تبادل أسرى مع سورية، وقد كتب في مذكراته التي نشرها أن “المعلومات التي قدّمها إلى السلطات السورية ساعدت القوات العسكرية السورية والمصرية، في حرب تشرين الأول/ أكتوبر (حرب يوم الغفران) عام 1973، واحتلال مرصد جبل الشيخ. ولكنّ ضباطًا في جيش الدفاع الإسرائيلي عدّوا ما ورد في مذكرات أبو جبل كلامًا مبالغًا فيه، بسبب عدم قدرة أعضاء الشبكة آنذاك على فهم الأمور العسكرية، وادعوا أن أعضاء شبكة التجسس قدموا معلومات هامشية فقط. لكن أنشطة شبكة التجسس السورية استمرت على مر السنين، وتضمنت جمع معلومات وصور لقواعد الجيش الإسرائيلي ومعسكراته في مرتفعات الجولان وفي شمال البلاد، ومعلومات محددة حول انتشار الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ، وحقول الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي، ومحاولات تدمير مستودعات الذخيرة للجيش الإسرائيلي، وزرع الألغام في المستودعات العسكرية، وجمع أسلحة ووسائل تخريب، وإرسال مغلفات ناسفة إلى مسؤولين وقادة، وتخطيط لخطف وإصابة طيار سوري هرب بطائرته إلى إسرائيل عام 1989، وأكثر من ذلك.
في هذا الوقت، شعر أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، بالإحراج من تجسس إخوانهم في الجولان لصالح الحكومة السورية. وقال أحد كبار أبناء الطائفة الدرزية، كمال منصور، عن هذه الأنشطة في العام 1973: “هذه مسألة خطيرة. يجب على إخواننا الدروز في مرتفعات الجولان، الاختيار بين خيارين: إما قبول خط الطائفة الدرزية في إسرائيل: الولاء لدولة إسرائيل دون تحفظ، وإما تحمّل النتائج”. وأضاف: “المؤلم في هذه القضية هو أن السلطات الإسرائيلية عاملت الدروز في الجولان بكل احترام، وحاولت تطويرهم ومساعدتهم وقدمت لهم خدمات أكثر من الخدمات التي حصلنا عليها نحن بعد إقامة الدولة في العام 1948. على إخوتنا الدروز في مرتفعات الجولان، تذكر أن السوريين لا يريدون مصلحتنا ولا مصلحتهم، وأن كل هذه الأنشطة التي يقومون بها في الجولان، إنما تضر وتمس بالعلاقات الطيبة لنا مع اليهود، وواجب كل درزي من أبناء الجولان استنكار أعمال السوريين وأتباعهم في الهضبة”.
لكنّ دروز الجولان استمروا في التمسك بموقفهم المعادي لدولة إسرائيل، وتشجيع أطفالهم على ثقافة معادية لإسرائيل، وحين يكبرون ينجذبون إلى القيام بأعمال تخريبية ضد أمن دولة إسرائيل، أحد أولئك تحدث إلينا وقال: “من الطبيعي أن نحارب السلطات الإسرائيلية”، وقد انضمّ إلى خلية تخريبية خلال سنوات الثمانينيات، وصدر حكم عليه بالسجن 12 عامًا في السجون الإسرائيلية، وما زال متمسكًا برأيه: “لن نوافق أبدًا، على وجود الحكم الإسرائيلي فوق أرضنا”. وبلغ عدد المعتقلين منذ عام 1967، من أبناء السكان الدروز في الجولان، نحو 800 درزي، بتهمة التجسس أو التخريب أو التحريض، وحكم عليهم بالسجن سنوات طويلة. وظل مئات آخرون منهم رهن الاعتقال الإداري لفترات قصيرة، من دون قرار من المحكمة، بعضهم -بحسب الدروز- اعتُقلوا ظلمًا وعدوانًا.
التفسير الإسرائيلي التقليدي لعناد سكان الجولان الدروز في عدم قبول سلطة إسرائيل، ينقسم إلى قسمين: الأول الخوف من مضايقة الحكم السوري للدروز في الأراضي السورية؛ والثاني احتمال عودة الجولان إلى سورية ذات يوم، ومن ثم تصفية الحساب معهم والانتقام منهم. دروز الجولان من جهتهم يرفضون هذه التفسيرات، ويواصلون الادعاء بحماسة أنهم موالون لسورية دون أعذار، ودون أسباب سوى صدق انتمائهم إلى وطنهم. وهنا يوضح سلمان فخر الدين، من مجدل شمس: “نشأنا سوريين على كل شيء، ونحن تحت احتلال دولة عنصرية لا تريدنا.. الدروز غير مرحب بهم حقًا في إسرائيل، وأعني أيضًا إخواننا في بيت جن ودالية الكرمل، وفي كل مكان آخر في إسرائيل. إسرائيل دولة ترفضنا، والعنصرية ضد العرب أو ضد الدروز في كل مكان”.
في عام 1980، بدأت الحكومة الإسرائيلية تمهّد الطريق لضم مرتفعات الجولان إلى إسرائيل، عبر إغراء السكان للحصول على الجنسية الإسرائيلية. وقد أثارت تلك المحاولات معارضة شديدة من قبلهم، ففي اجتماع عام ومفتوح لجميع سكان قرى شمال الجولان، تقرر فرض مقاطعة كاملة على كل من يحصل على بطاقة هوية إسرائيلية. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1981، سنّ الكنيست الإسرائيلي قانون مرتفعات الجولان، وباتت السيادة الإسرائيلية على الجولان تطبّق فعليًا، في المستوطنات الإسرائيلية في الجولان، وسادت أجواء البهجة والفرح، فيما سادت في القرى الدرزية أجواء الحزن والغضب.
وقال وزير الدفاع السوري آنذاك مصطفى طلاس: “إن إعلان إسرائيل ضمّ الجولان هو بمنزلة إعلان الحرب على سورية، وأنها سترد على ذلك بحد السيف”. وتحسّبًا لأي تصعيد، تأهبت قوات الجيش الإسرائيلي في الجولان بكامل استعداداتها على الحدود، حيث قام وزير الدفاع أرييل شارون بجولة في الهضبة، والتقى قائد المنطقة الشمالية ورؤساء المستوطنين، وجابت سيارات جيب حرس الحدود الشارع الرئيسي في مسعدة، وكان من المتوقع أن تعمّ تظاهرات عنيفة في الجولان، إلا أن السكان والأطفال استقبلوهم بحمل رايات سوداء. وقال أحد سكان مجدل شمس ردًا على هذه الخطوة الدراماتيكية: “هذا يوم أسود لنا جميعًا”. على إسرائيل أن تفهم أننا “لا ننتمي إليها. هذه أرض سورية، ونحن مواطنون سوريون”.
كانت الحكومة تأمل في أن يكون قانون ضمّ مرتفعات الجولان قادرًا على فرض الجنسية الإسرائيلية على السكان الدروز، لكنهم استمروا في عنادهم وإصرارهم على عروبة مرتفعات الجولان. ففي 14 شباط/ فبراير 1982، أعلنوا إضرابًا عامًا في القرى الدرزية في الجولان، استمر قرابة ستة أشهر، ورافقته سلسلة طويلة من الأعمال اللاعنفية التي أثارت التأييد والتضامن في سورية وأرجاء العالم. وقد أسهم الإضراب في حدوث أضرار كبيرة على المصانع في كريات شمونة، وأماكن عمل عديدة، كان يعمل بها الدروز الذين رفضوا القدوم للعمل. وكانوا طوال الوقت يوضحون للإسرائيليين: “نحن سوريون، ونشعر بأننا سوريون، هذه هي مشاعرنا، وهذه حقيقتنا، احترموا ذلك”. إلا أن ولاءهم القديم لوطنهم لم يكن لدى الجميع؛ حيث صرّح لنا دروز آخرون: “في سورية، لا يتحدثون عنا، أو عن مشكلاتنا، لقد نسونا. يتذكروننا فقط، عندما يريد النظام ترويح وخدمة مصالحه. اليوم مشكلات الدروز الرئيسية في الجولان هي قضية المياه وقضايا الأرض. وبحسب جمعية الجولان للتنمية، ومقرها مجدل شمس، يُخصص لكل مستوطن إسرائيلي في الجولان 700 متر مكعب من المياه لكل دونم من الأرض، بينما يخصص للمزارعين الدروز ما بين 70 و 100 متر مكعب. مشكلة أخرى ظهرت في العام الماضي هي خطة بناء حوالي 40 توربينة رياح على الأراضي الدرزية. ونتيجة لذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة، أصيب فيها متظاهرون واعتقل آخرون. وقالوا: “هذه الأراضي كانت لنا منذ قرون، لقد ولدنا هنا وسنبقى هنا”، لكن الحادث الأخطر بالنسبة إلى دولة إسرائيل، كان في 15 أيار/ مايو2011، خلال يوم النكبة الفلسطينية، عندما تم اختراق الحدود مع سورية إلى مجدل شمس، إذ قُتل تسعة فلسطينيين آنذاك، وجرح عشرات، وتمكن مئات من عبور الحدود، والوصول إلى مجدل شمس وسط هتافات الدروز الذين شجعوهم وساعدوهم. ومع اندلاع الحرب الأهلية السورية؛ أظهر الدروز في الجولان ولاءهم لنظام الأسد. ففي عام 2015، هاجموا سيارة إسعاف عسكرية، كانت تمر بمجدل شمس، وتنقل مصابين إلى مستشفى في إسرائيل، وأسفر ذلك عن مقتل أحدهم، وإصابة شخص آخر بجروح، وفرّ الجنود من المكان بسيارة إسعاف ونجوا بأعجوبة.
وأكثر ما يخشاه السكان الدروز في الجولان اليوم هو مصير إخوانهم الذين بقوا في الأراضي السورية. ففي عام 2017، هددوا بعبور الحدود لمساعدة إخوانهم في قرية (خضر) التي تقع على بعد حوالي 4 كم شرق مجدل شمس، بعد أن قتل مقاتلو “جبهة النصرة”، تسعة أشخاص، وجرحوا 23 درزيًا من أبناء القرية، حينئذ أعلنت إسرائيل أنها ستمنع العصابات والمتمردين من إيذاء الدروز الذين يعيشون في الجولان السوري في قرى جبل الشيخ. وفي كل حملة انتخابية للكنيست أو للسلطات المحلية، تندلع أعمال شغب في القرى الدرزية في الجولان، بعد محاولة الدروز الموالين لسورية إغلاق صناديق الاقتراع، وتخريب الانتخابات، بالرغم من أن عدد المرشحين لرئاسة السلطات المحلية محدود وقليل، وهم يعيشون تحت طائلة المقاطعة الاجتماعية والتحريم الديني في أجواء معادية لإسرائيل في القرى الدرزية في الجولان، ما تزال مستمرة منذ 53 عامًا، وهي اليوم أقل قوة بكثير مما كانت عليه في السبعينيات والثمانينيات، إذ كانت سنوات مشبعة بأنشطة تجسس تخريبية ومخططات ضد الدولة. إلا أن هذه الأجواء العدائية تغيب وتختفي في أثناء العلاقة مع الإسرائيليين الذين يزورون الجولان، ويمرون من داخل هذه القرى، ضمن الرحلات السياحية، وأثناء سفرهم من وإلى جبل الشيخ خاصة، كثير من الدروز يكسبون عيشهم من السياحة الداخلية: المطاعم، الفنادق والغرف السياحية، البيع والتجارة. لكن الحضور السياحي الإسرائيلي يتضاءل في الجولان بعد كل أحداث أمنية وأعمال شغب، والعديد من السياح يهددون بعدم الشراء منهم بعد الآن. لكنهم يدركون أن لا بديل عن عروس (اللفة) اللبنة الدرزية، وسوق الكرز، وعروض السحلب الساخن، والكنافة والعسل، وبركة رام، وساحة سلطان الأطرش، وتل الصياح في عين التينة، التي تلاشت بعد دخول السكايب كوسيلة للاتصال بين العائلات السورية المشتتة. إلا أن استمرار الحرب الأهلية في سورية، والضرر الكبير الذي لحق بمكانة نظام الأسد، دفع العديد من الدروز في مرتفعات الجولان إلى إعادة حساباتهم، وإعادة التفكير في مستقبلهم، والمزيد من الشباب مهتمون بالمضي قدمًا، وليس العيش وفقًا للتقاليد والإملاءات. يريدون جواز سفر إسرائيلي، لا وثيقة سفر. حوالي عشرة بالمئة من جميع الدروز اليوم لديهم جنسيات إسرائيلية. مفعول الحرمان الديني والمقاطعة الاجتماعية المفروضة على الدروز الذين يعترفون بالحكم الإسرائيلي يتضاءل كثيرًا، لكن الغالبية العظمى ما تزال موالية لسورية، ولا تنسى لحظة واحدة هويّة الوالدين.
تهدف المنشورات التي أنتجها الموقع إلى سرد قصة ترحيل النازحين السوريين وسكان الجولان المحتل وتدمير المدن والقرى في أثناء اجتياح الجيش الإسرائيلي في 9 حزيران/ يونيو 1967 وبعده. وذلك للفت الانتباه إلى المأساة التي حدثت وما زالت مستمرة منذ عام 1967، والتأكيد على أهمية إنهاء الاحتلال في الجولان وعودة اللاجئين.
عنوان المقال طرد السوريين من الجولان
الكاتب شلمومو مين
مكان النشر وتاريخه نعموش: 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
المترجم أيمن أبو جبل
مركز حرمون